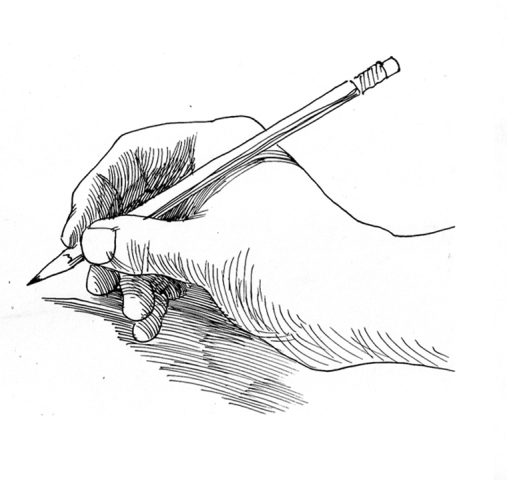إن الله لا يعاقب العبد قبل إعطائه فرصة كي يتوب ويؤوب، وهو الغني عن عقابه، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون"، فلم لا نعطي الفرصة للآخرين كي يستشعروا أخطاءهم بأنفسهم ويعملوا، بدفع بسيط، على إصلاحها، فإن لم يفعلوا فلم نؤذ أنفسنا بردود فعل من أنفسنا تؤذينا، بل نخطو خطوة تالية مع زيادة ذخيرة الدعاء، ومن الله الإجابة.
والحذر الحذر من التوغل بغير هدى في طريق المداراة وإلا فسيأخذ الأمر بعداً خطيراً عند صرفه عن حقيقته، وخلطه بما ليس من أعماله، فالمداراة فيها الحكمة والتبصر بما يصدر عن أخيك عند معالجة الأخطاء بطريقة هينة لينة لا يجفل معها قلب المخطئ، ولا ينأى بعيداً مصراً على فعله، وقد يأخذ هذا الجانب فترة من الوقت حتى يحصل المراد.
والإحسان إلى الناس دون أن يحدث تغير في معاملتهم، يدفع البعض إلى التذمر، والعمل معاملتهم بالمثل، وعدم الإحسان إليهم، حتى أصبحوا مثلهم في الإساءة وإخلاف المواعيد، والتسويف والبذاءة، ناسين أن طيب التعامل إنما يفعلوه لأن الله عز وجل قد أمرهم به وإن أساء الآخرون.
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يصل رحمه، ويناله مع ذلك الأذى، أن يستمر في عمله الخيّر ولا يقطعه، فكيف يتم التغيير إذا واجهنا الإساءة بمثلها وبالغنا في الخصام..؟
وأين ما يحمله المسلم في قلبه من حب لإخوانه والحرص على هدايتهم ، والتحلي بالصبر واحتساب الأجر من الله... ؟
صحب عبد الله بن المبارك رجلاً سيئ الخلق في سفر فكان يحتمل منه ويداريه. فلما فارقه بكى، فقيل له في ذلك، فقال بكيته رحمة له، فارقته وخلقه معه لم يفارقه.
لقد علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ألا نلتفت إلى حظوظ أنفسنا عندما نتعامل مع الناس، بل ندفع عن أنفسنا التعدي بالعفو الذي يريح القلب ويطفئ نار العداوات.
قال عليه الصلاة والسلام: "من كتم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين،يزوجه منها ما شاء"
خاصم رجل الأحنف بن قيس فقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشراً
فقال الأحنف: لكنك إن قلت عشراً لم تسمع واحدة
لما عفوت ولم أحقد على أحد
أرحت من هم العداوات
إني أحيي عدوي عند رؤيته
لأدفع الشر عني بالتحيات
وأظهر البشر للإنسان أبغضه
كأن قد ملأ قلبي محبات
وقد يبدو منا ما لا يجمل من تصرف وتجاوز الحد مع الآخرين، فينزعج القلب وتظهر الرغبة في الاعتذار وطلب الصفح من الذي أخطأت في حقه، مع مراغمة الشيطان والنفس في ذلك، فأسرع إلى تطييب قلب صاحبك قبل أن تخف حدة الانزعاج ويقل الاهتمام به، فقد لا ترى ذلك المرء مرة أخرى، فيبقى الاثم، وتنساه أنت ولكن تفاجأ بصاحبك يوم العرض يطالب بأخذ حقه.
والحذر الحذر من التوغل بغير هدى في طريق المداراة وإلا فسيأخذ الأمر بعداً خطيراً عند صرفه عن حقيقته، وخلطه بما ليس من أعماله، فالمداراة فيها الحكمة والتبصر بما يصدر عن أخيك عند معالجة الأخطاء بطريقة هينة لينة لا يجفل معها قلب المخطئ، ولا ينأى بعيداً مصراً على فعله، وقد يأخذ هذا الجانب فترة من الوقت حتى يحصل المراد.
والإحسان إلى الناس دون أن يحدث تغير في معاملتهم، يدفع البعض إلى التذمر، والعمل معاملتهم بالمثل، وعدم الإحسان إليهم، حتى أصبحوا مثلهم في الإساءة وإخلاف المواعيد، والتسويف والبذاءة، ناسين أن طيب التعامل إنما يفعلوه لأن الله عز وجل قد أمرهم به وإن أساء الآخرون.
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يصل رحمه، ويناله مع ذلك الأذى، أن يستمر في عمله الخيّر ولا يقطعه، فكيف يتم التغيير إذا واجهنا الإساءة بمثلها وبالغنا في الخصام..؟
وأين ما يحمله المسلم في قلبه من حب لإخوانه والحرص على هدايتهم ، والتحلي بالصبر واحتساب الأجر من الله... ؟
صحب عبد الله بن المبارك رجلاً سيئ الخلق في سفر فكان يحتمل منه ويداريه. فلما فارقه بكى، فقيل له في ذلك، فقال بكيته رحمة له، فارقته وخلقه معه لم يفارقه.
لقد علمنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ألا نلتفت إلى حظوظ أنفسنا عندما نتعامل مع الناس، بل ندفع عن أنفسنا التعدي بالعفو الذي يريح القلب ويطفئ نار العداوات.
قال عليه الصلاة والسلام: "من كتم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين،يزوجه منها ما شاء"
خاصم رجل الأحنف بن قيس فقال: لئن قلت واحدة لتسمعن عشراً
فقال الأحنف: لكنك إن قلت عشراً لم تسمع واحدة
لما عفوت ولم أحقد على أحد
أرحت من هم العداوات
إني أحيي عدوي عند رؤيته
لأدفع الشر عني بالتحيات
وأظهر البشر للإنسان أبغضه
كأن قد ملأ قلبي محبات
وقد يبدو منا ما لا يجمل من تصرف وتجاوز الحد مع الآخرين، فينزعج القلب وتظهر الرغبة في الاعتذار وطلب الصفح من الذي أخطأت في حقه، مع مراغمة الشيطان والنفس في ذلك، فأسرع إلى تطييب قلب صاحبك قبل أن تخف حدة الانزعاج ويقل الاهتمام به، فقد لا ترى ذلك المرء مرة أخرى، فيبقى الاثم، وتنساه أنت ولكن تفاجأ بصاحبك يوم العرض يطالب بأخذ حقه.