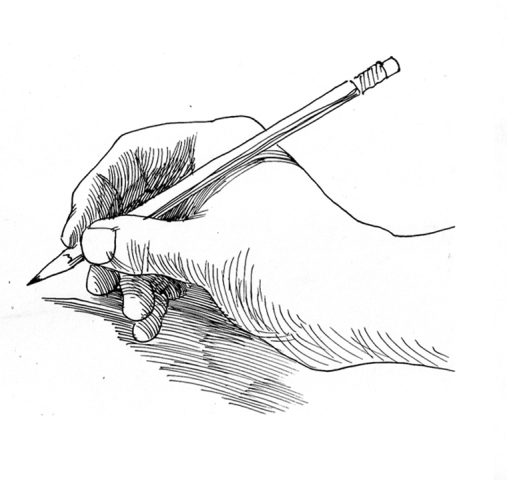من ألف المنكر واستأنس بالمعصية فلن ينتبه للعقوبة، وستمر عليه وكأنها لم تكن، ولن يشعر بالإصابات والخسائر الفادحة التي مُني بها، فقد ألف كذلك العقوبة وفقد الإحساس بأن حاله التي هو فيها عقوبة عاجله الله بها حرمته نعيم الطاعة.
رُوي في الاسرائيليات أن أحد أحبار بني إسرائيل قال مخاطبا ربه: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني...؟
فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي.
لا إله إلا الله، كم تمر علينا من الساعات دون ذكر ودون عمل، نأنس بها ونلهو، ولا نعلم أنها عقوبة فقدنا بها درجات، وأعظم من ذلك بلاء الفرح والسرور بهذه العقوبة، والسعي للزيادة منها، كالفرح باكتساب المال الحرام، وارتكاب الموبقات، وما ذاك إلا لانطماس البصيرة الذي يخشاه أرباب الأعمال الصالحة.
قال أبو داود الحفري: دخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي، فقيل له: ما يبكيك ...؟
قال: إن بابي لمغلق، وإن ستري لمسبل، ومنعت جزئي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا لذنب أذنبته.
وليتدبر من وصلت به الحال إلى الفرح بالسلامة، والاستئناس مع التقصير والتفريط في قول ابن الجوزي، رحمه الله، عندما يقول: واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين، وطمس القلوب، وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض.
ومن ذلك أن تسلب من العبد طاعات كان مداوما عليه، مثل قلة ارتياد مجالس العلماء وحلق الذكر، ومثل قبض اليد أن تمتد في بذل المعروف، ومثل التأخر عن الصلاة في حينها، حتى لا يبالي إن خرج وقتها، فلا يجد في نفسه حرقة لذلك وألم، في حين أن سلفنا الكرام كانوا يحرصون على الصلاة جماعة في وقتها، وإن كانوا في حالة شدّة ومرض، بل أن بعضهم كانت تقبض روحه وهو في الصف.
ومن توالت عليه العقوبات فقد وقف على حافة الخطر، وعرض نفسه للهلاك، وهذا ما يحذرنا منه ابن القيم ويصيح بنا ألا نتعرض للمعاصي فيقول: الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل.
ويقول أيضا: انظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب، وأن الله منع عصمته عنك، وانظر إلى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب وقعودك عن تداركه، مصرا عليه مع تيقنك نظر الحق إليك، فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة، قال الله تعالى {ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم}، وما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا.
رُوي في الاسرائيليات أن أحد أحبار بني إسرائيل قال مخاطبا ربه: يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني...؟
فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي.
لا إله إلا الله، كم تمر علينا من الساعات دون ذكر ودون عمل، نأنس بها ونلهو، ولا نعلم أنها عقوبة فقدنا بها درجات، وأعظم من ذلك بلاء الفرح والسرور بهذه العقوبة، والسعي للزيادة منها، كالفرح باكتساب المال الحرام، وارتكاب الموبقات، وما ذاك إلا لانطماس البصيرة الذي يخشاه أرباب الأعمال الصالحة.
قال أبو داود الحفري: دخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي، فقيل له: ما يبكيك ...؟
قال: إن بابي لمغلق، وإن ستري لمسبل، ومنعت جزئي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا لذنب أذنبته.
وليتدبر من وصلت به الحال إلى الفرح بالسلامة، والاستئناس مع التقصير والتفريط في قول ابن الجوزي، رحمه الله، عندما يقول: واعلم أنه من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين، وطمس القلوب، وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثارها سلامة البدن وبلوغ الأغراض.
ومن ذلك أن تسلب من العبد طاعات كان مداوما عليه، مثل قلة ارتياد مجالس العلماء وحلق الذكر، ومثل قبض اليد أن تمتد في بذل المعروف، ومثل التأخر عن الصلاة في حينها، حتى لا يبالي إن خرج وقتها، فلا يجد في نفسه حرقة لذلك وألم، في حين أن سلفنا الكرام كانوا يحرصون على الصلاة جماعة في وقتها، وإن كانوا في حالة شدّة ومرض، بل أن بعضهم كانت تقبض روحه وهو في الصف.
ومن توالت عليه العقوبات فقد وقف على حافة الخطر، وعرض نفسه للهلاك، وهذا ما يحذرنا منه ابن القيم ويصيح بنا ألا نتعرض للمعاصي فيقول: الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل.
ويقول أيضا: انظر إلى ما كان من انخلاعك عن الاعتصام بالله حين إتيان الذنب، وأن الله منع عصمته عنك، وانظر إلى ما كان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب وقعودك عن تداركه، مصرا عليه مع تيقنك نظر الحق إليك، فإن العبد لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة، قال الله تعالى {ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم}، وما خلى الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب إليك سبيلا.